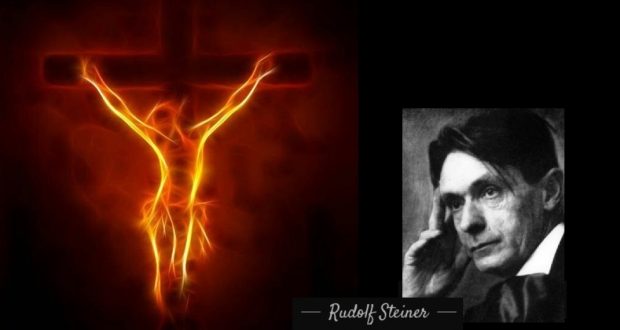– إن الإنسان سيدرك بطريقة واعية عبارة “ملكوت السماوات نزل إلى الارض” أي “المسيح”..
بتصرف زينة طالب –

عند إلقاء نظرة سريعة على تاريخ التطور البشري، نرى أحداثاً ذات أهمية رئيسة أو ثانوية قد برزت بوضوح كبير وكان لها التأثير قوي على تطوّر الحياة البشرية بأسرها.
إن أبرز وأعظم هذه الاحداث هو “سر الجلجثة” الذي بواسطته أصبحت المسيحية جزءاً لا يتجزأ من التطور الإنساني. ففي العصر الذي حل فيه هذا السر، كان للإنسان إدراكاً ووعياً مختلفاً تماماً عنه في الأوقات اللاحقة، من أجل كل ذلك يجب أن ينشأ في عصرنا الحالي اليوم، حالة جديدة من الوعي والإدراك والفهم، فكانت مهمة “الانثروبوصوفيا” ان تعمل على تطوير وتحديث مفهوم جديد لـ”سر الجلجثة” يتماشى مع روح عصرنا الحالي.
قبل ثلاثة أو أربعة آلاف سنة مضت، كان الإنسان آنذاك يدرك بالفطرة أنه ينتمي الى عالم روحي، قبل أن يهبط إلى عالم الأرض ليلبس الجسد المادي. وكان يعلم أنه يتألف من نفس وروح، قد نزل بواسطة قوى إلهية إلى العالم الأرضي، بالإضافة إلى أن مفهوم الموت عنده كان مختلفاً تماماً عن مفهومنا الحالي، والسبب في ذلك يعود إلى قدرته بالعودة في الذاكرة إلى الوراء، إلى ما قبل وجوده المادي على الأرض عندما كان كائناً مكوّناً من نفس وروح، مدركاً أن هذا الجزء الذي كان يعيشه قبل بداية حياته الأرضية سيعيشه مجدداً بعد الموت.
في تلك الأزمنة، ظهرت مؤسسات دينية ومدارس تعليمية أو ما يسمى بالمدارس السرانية، حيث كان الإنسان يتلقن فيها دروساً وتعاليم خاصة عن كل ما يمكن معرفته عن تلك المرحلة من حياته قبل مجيئه إلى الارض. من خلال تلك المدارس، وصل إلى يقين تام، أن قبل وجوده على الأرض كان يعيش بين النجوم، وأيضاً بين كائنات روحية سامية، تماماً كما يعيش هنا على الارض بين النباتات والحيوانات والجبال والأنهار. كان يعي أيضاً انه نزل من عالم النجوم إلى عالم الأرض، وأن تلك النجوم ليست فقط أجراماً سماوية مادية، بل ان كل نجم من تلك النجوم مسكون بكائنات روحية كان على إرتباط بها قبل نزوله إلى الارض، وكان يعلم ايضاً أنه عند مغادرته جسده المادي هذا ساعة الموت، سيعود إلى عالم النجوم، أو بمعنى آخر إلى العالم الروحي. كان يرى ان للشمس أهمية روحية قصوى لأن أكثر الكائنات سموا كان يسكنها، ما كان يعرف “بإله – الشمس” الجليل.
من أهم الأسرار التي كانت تعلمها تلك المدارس للمريد، أن “إله – الشمس” الجليل، قد أعطاه القوة قبل أن ينزل إلى الأرض، لكي يصبح قادراً بواسطتها الى العودة بالإتجاه الصحيح نحو عوالم النجوم الروحية. فمعلمو هذه المدارس، كانوا يلقنون المريد الاسرار الروحية، وكان بدوره يلقن أخوته الآخرين بأن قوة الشمس الروحية، والنور الروحي الذي يواكبه وينتقل معه إلى ما بعد الموت، هو ذاته الذي رافقه خلال ولادته في العالم الأرضي. كما نلاحظ أن العديد من الصلوات والتعاليم السامية التي وضعها المعلمون في مدارسهم كانت من أجل تمجيد ووصف “إله – الشمس” السامي. كانوا يعلمون تلاميذهم أن الإنسان الذي يمرّ عبر بوابة الموت، عليه أن يدخل اولاً إلى فلك أصغر النجوم وكائناتها ليعود ويرتفع بعد ذلك إلى ما بعد الشمس. هذا العبور لا يمكن أن يتم ما لم يمنحه إياه “إله – الشمس”، وبالتالي كانت قلوب الذين فهموا ووعوا كل ذلك تتوهج حماساً عندما كانوا يقدمون صلواتهم إلى الروح أو الإله الذي يسكن الشمس والذي يهبهم الخلود. حتى أن كل الترانيم والتمارين المخصصة للشمس، كان لها التأثير القوي على مشاعر الإنسان وعلى كل ناحية من نواحي حياته الروحية، فعند ممارسة طقوس “عبادة الشمس” كان الإنسان آنذاك يشعر بأنه متحّد مع إله الكون.

كانت تقام بين تلك الشعوب التي سادت لديها هذه العادات، إحتفالات وعبادات وطقوس سرانية خاصة لتكريم وتعظيم الشمس. يتألف الطقس كقاعدة أساسية من صورة الإله الذي وضع في القبر، ليخرج منه من جديد بعض بضعة أيام. وكان كل ذلك علامة واضحة وإشارة جلية الى حقيقة وجود إله في الكون وهو “إله – الشمس” الذي كان على الدوام، يقيم الإنسان إلى الحياة بعد أن يستسلم للموت.
عند ممارسة هذا الطقس، كان الكاهن الأعلى الذي يقوم بهذه المهمة يلقن تلاميذه هذه الأسرار قائلا لهم: “هذه الشعائر والطقوس هي استذكار لحقيقة انه قبل أن تنزلوا إلى الأرض، كنتم في “مملكة- الروح” مسكن “إله – الشمس”. إنظروا إلى الشمس التي تشع بالأنوار، إن هذا الجزء المرئي هو فقط المظهر الخارجي “لإله – الشمس”، وخلف بريقها تجدون هذا الإله الأزلي الذي يمنحكم الخلود”. ويتابع: “منذ ولادتكم، إنطلقتم من عالم “إله- الشمس”، وعندما ترحلون من خلال بوابة الموت، ستجدون نفوسكم من جديد في مملكته من خلال تلك القدرة الخفية التي وضعها “إله – الشمس” في قلوبكم”.
لقد اصبح فيما بعد معروفاً عند الكهنة في تلك المدارس السرانية، أن “إله – الشمس” المقدس، الذي كانوا يتحدثون عنه من قبل، هو نفسه “الإله” الذي تجسد في وقت لاحق، واطلق عليه “المسيح”. فقط قبل أن يحدث “سر الجلجثة” كان بإستطاعة هؤلاء الكهنة ان يتكلموا ويعلموا تلك الحقائق الروحية. لأنه كان مستحيلا وبلا جدى، معرفة اي حقيقة عن “المسيح” على هذه الأرض، إنما على الإنسان أن يرتقي بالروح لمعرفة أسرار الشمس التي تتعلق بالمسيح، ولا يمكن ان يتم كل ذلك إلا من خارج وما وراء الأرض المادية. لم يكن صعب على الإنسان في ذلك الزمان قبول مثل هذه التعاليم، لأنه كانت لديه بالفطرة ذاكرة قوية وواضحة عن عالم المسيح. لكن عندما شاركت طبيعة الإنسان المادية في عملية تطور البشرية، فقد الإنسان هذه الذاكرة عن حياته ما قبل مجيئه إلى الأرض وعن حقيقة حياته الروحية.
دعونا نتصور للحظة مرور الإنسان بوابة الموت. إنه يعبر تدريجياً نحو “كون” مرصع بالنجوم، إلى تلك العوالم التي يرى من خلالها النجوم والشمس لكن من الجانب الآخر. هنا على الأرض نرى الشمس بالطريقة المعتادة، أما بعد الموت، فإننا ننتقل إلى الكون النوراني ونرى الشمس من الجانب الآخر، ليس كفلك مادي فارغ، إنما كمملكة تعجّ بالكائنات الروحية المتنوّعة.
منذ عهد بعيد قبل حدوث “سر الجلجثة”، كان بإمكان الإنسان أن يرى المسيح في الشمس من الجانب الآخر قبل ولادته وبعد موته على السواء. وكان معلمو تلك المدارس السرانية قادرين على تجسيد وإسترجاع هذه الرؤية ونقلها إلى أذهان وعقول تلاميذهم، لكي يوقظوا فيهم الفهم والوعي والمعرفة الحقيقة لما كانوا يبصرونه من الجانب الآخر من الشمس قبل مجيئهم إلى الأرض. ثم جاء العصر، الذي بدأ منذ حوالي ثمانمئة سنة قبل “سر الجلجثة”، حيث اصبحوا عاجزين على إحياء هذه الذاكرة على الإطلاق.
لم يعد بإستطاعة الإنسان أن يرى “المسيح” من خلال الشمس، وكأن قوة المسيح قد تخلت عنه فأصبح غير قادر على الإطلاق من معاينة تلك العوالم الروحية. في هذا الوقت بالذات ولأول مرة، واجه الإنسان مبدأ “الخوف من الموت“، ففي الأزمنة السابقة عندما كان يرى هذا الموت وهو لا يزال في جسده المادي، كان يعرف أنه لن يذوقه فعلياً، لأنه كان عالماً انه ينتمي الى ملكوت المسيح، بينما الآن أصبح قلقاً بشكل كبير، لأن هذه المعرفة والصلة التي كانت تجمعه بالمسيح قد إنقطعت الى حد كبير، وكان من تداعيات هذا الإنقطاع، عدم القدرة على رؤية العوالم الروحية كما في السابق، وفقد أثر المسيح في العالم الأرضي.
في ذلك الزمان، عندما لم يعد بإستطاعة البشرية رؤية المسيح في الجانب الآخر من الشمس، نزل “المسيح” إلى الأرض من أجل أن نراه ونلمسه ونعرفه هنا في عالمنا المادي. حدث بعد ذلك شيء عظيم في تطور العوالم الروحية، ما لم يكن ممكناً حصوله ابداً في دائرة المعرفة البشرية. ففي عالمها الروحي، كانت الكائنات الروحية الأعلى مرتبة من الإنسان، أي تلك التراتبية الملائكية بكل درجاتها وصولاً إلى أعلاها، كانت كلها تمرّ بتحولات وتغييرات وترقيات من دون أن تعرف الولادة والموت كما نعرفه نحن البشر.
ان المدارس السرانية في ذلك الوقت، كانت مدركة تماماً أن الإنسان هو وحده الذي يمرّ بهذه الدائرة، دائرة الحياة والموت. لكن عندما لم يعد بإستطاعة البشرية معرفة كيفية الوصول إلى المسيح، جاءها هو بذاته، متجسداً من السموات العليا نزولاً إلى الارض، فكان من الضروري أنه وكإله أن يختبر ويخضع لما لم يخضع له أي إله (نبي) سابق. أصبح “المسيح” إنساناً بشخص يسوع، ومشى طريق البشر وهو إله، تلك الطريق التي تقوده في النهاية إلى الموت البشري.
ليست الحقيقة الأساسية لـ”سر الجلجثة” مجرد قضية إنسانية وحسب، إنما هي مسألة روحية وتصميم إلهي من العالم السماوي، به ينبغي على “إله- الشمس” الجليل، أن يوحد مصيره مع الجنس البشري، وهذه الوحدة لا تتم إلا من خلال مرور “الإله” ببوابة الولادة والموت، ذلك من أجل إعادة إحياء الاتصال الذي فقد بين الإنسان والسماوات، كما كان في السابق (قبل السقوط أو بما يُعرف خطيئة).
أول من تشارك “أسرار الجلجثة”، هم الرسل وتلاميذ المسيح، لأنه، وحتى القرن الرابع عشر، قليلون هم الذين كانوا يعون عندما ينظرون بالروح إلى الشمس، أن المسيح هو “إله – الشمس” الذي نزل من السماء، ومشى على الأرض. فمنذ “الجلجثة” حتى يومنا هذا، لم يتبق من تلك المعرفة وهذه الحقائق إلا كلمات الإنجيل السطحية، التي تحدثنا عن هذا السر العميق والعظيم. كان الرسل يقولون لأنفسهم، أن أشعة الشمس كانت تشع من عيون يسوع نحوهم، ومن كلماته تندفع قوة دفئها المعطاء. وعندما يتنقل بينهم، كأن الشمس بذاتها كانت ترسل نورها وطاقتها إلى العالم. ولأنهم كانوا يعرفون كل ذلك معرفة كبيرة، فإن موقفهم من موت المسيح كان صحيحاً وحقيقياً، وبقوا تلاميذه حتى بعد موته على الارض.
تطلعنا العلوم الروحية، أنه عندما غادر المسيح جسد يسوع الناصري، تنقل بجسده الروحي بين التلاميذ وزودهم بالمزيد من العلوم والمعرفة. ثم وهبهم السلطة التي تمكنهم من الوصول الى تعاليمه، في كل مرة كان يظهر لهم بجسده الروحي. بيد أن هذه القوة والمقدرة تركتهم بعد حين.

في الزمن الذي اعتقد فيه الرسل انهم فقدوا فيه وجود المسيح مرة أخرى، أي في “عيد الصعود”، ترك في ذاكرتهم ووجدانهم قناعة وإيماناً، أن “إله – الشمس” الذي قد مشى معهم على الارض بشخص يسوع الناصري، قد اختفى كلياً عن أنظارهم. فوقع التلاميذ في حزن عميق، لا يمكن مقارنته بأي حزن آخر على الأرض. عندما كان يحتفل في المدارس السرانية القديمة بطقوس عبادة الشمس، كانت صورة الإله الذي وضع في القبر، والذي ارتفع بعد فترة من الزمن، تؤلم كثيراً المشاركين في هذا الطقس بسبب موت الإله، لكن هذا لا يمكن مقارنته مع حجم الحزن الذي ملأ قلوب تلاميذ المسيح.
إن كل معرفة لا تكون فعلاً عظيمة إذا لم تولد من رحم التعب والحزن ومن العمل الدؤوب الروحي والباطني. لا يستطيع أحد أن يصل إلى معرفة العالم الروحي من دون أن يختبر الألم الشديد وبعد أن يختبر أيضاً الطريقة التي تمكنه من التحرر منه.

خلال العشرة أيام التي تلت الصعود، كانت معاناة التلاميذ والرسل لا توصف، لأن المسيح قد اختفى كلياً عن انظارهم. نتيجة هذا الألم، ومن أجل أن يطفئوا حزنهم العميق، نشأ هناك “سر العنصرة”. إن الرسل بعد ان فقدوا البصيرة الفطرية والخارجية لرؤية المسيح، وجدوها ثانية في أعماق نفوسهم، بأحاسيسهم وتجاربهم الداخلية ومن خلال الألم والحزن.
دعونا نعود مجدداً إلى فترة ما قبل الجلجثة، حيث كان الإنسان لا يزال يحتفظ ببعض الذكرى عن حياته قبل بدايتها في العالم المادي، حين كان لا يزال يؤمن أنه قد نال من المسيح القوة لبلوغ الخلود.

أما الآن في زمن الجلجثة، إن تلك الطاقة البشرية لم تعد قادرة على النظر إلى الوراء، إلى العالم الروحي وإلى بداية وجوده على الأرض. إن تلاميذ المسيح حولوا طاقاتهم الفكرية الواعية لكي يحفظوا في ذاكرتهم ما حدث على الجلجثة. من خلال هذه الذاكرة، وبالإضافة الى ما قد نشأ لديهم من ألم ومعاناة، تجلّت في نفوسهم “الرؤية” التي كانت منسية، رؤية ما قد فقدته البشرية عندما لم تعد تمتلك الاستبصار الغريزي والروحي. كان الإنسان يعي تماماً، أنه في البدء كان متحداً مع المسيح قبل أن يولد على هذه الأرض، ومنه منح القدرة والمعرفة والوعي التي تقوده إلى الخلود. الآن وبعد عشرة أيام، بعد أن فقد الرسل القدرة على رؤية المسيح قالوا: “إننا عاينا “سر الجلجثة” وهذا يعطينا القوة والوعي لنشعر مرة أخرى بحقيقة طبيعتنا الخالدة”. على ضوء العلوم الروحية، إن “سر- العنصرة” تكشف لنا أن “سر- الجلجثة” قد حل مكان “أسطورة الإله – الشمس” في الأسرار القديمة. هذا ما تمثل رمزياً في ظهور “الالسنة من نار” في عيد العنصرة.
أدرك بولس الرسول بوضوح استثنائي، من خلال الوحي الذي جاءه في دمشق، أن المسيح هو “إله – الشمس” الذي عاش في جسد إنسان ومر ببوابة الموت. وكأحد المريدين القدماء في المدارس السرانية القديمة، كانت أولى قناعته الراسخة، أن الإنسان لا يمكنه ان يجد المسيح إلا بواسطة التبصر الذي من خلاله يبلغ العوالم الروحية. وأن الطائفة التي تعلن وتؤمن أن “إله – الشمس” قد سكن في جسد إنسان ومر عبر بوابة الموت هو أمر مستحيل، لأنه فقط من الجانب الآخر من الأرض نتمكن من رؤية “إله – الشمس”. بالرغم من أن إيمان بولس كان يستند إلى المعرفة المكتسبة في المدارس السرانية القديمة إلا أنه كان معادٍ للمسيحية، فمن خلال الوحي الذي نزل عليه في طريقه الى دمشق (الشام) أدرك جلياً أن الإنسان لم يعد بحاجة للإنتقال إلى العالم الروحي ليبصر المسيح، لأنه في الحقيقة “هو” قد نزل إلى الأرض من اجل هذا الهدف بالذات.
لو لم يظهر المسيح على الأرض، ولو كان قد بقي فقط ك “إله- الشمس”، لكانت البشرية على الأرض قد تلاشت تدريجياً. إذا أصبح جميع البشر يؤمنون أن كل وجود هو فقط مادي، فإنهم سوف يفقدون قوة الروح في داخلهم، ويصبحون عاجزين ومرضى. هذا في الواقع ما كان من شأنه ان يحدث، ما لم ينزل “المسيح” برحمته الإلهية واللامتناهية من العالم الروحي ويتجسد في عالمنا المادي على الأرض.
قد يسأل البعض أن هناك العديد من البشر الذين لا يريدون معرفة أي شيء عن المسيح، ولا يريدون ان يؤمنوا به، وعلى الرغم من ذلك لم يصبحوا ضعفاء ولا مرضى؟ والجواب هو: ان المسيح قد ظهر على الارض في الزمن الذي حل فيه “سر الجلجثة” ليس لإعطاء تعاليم جديدة للبشرية، بل لكي يجعل حقيقة ظهوره على الأرض قوية وفعالة. لقد مات من أجل جميع البشر. حتى أن الطبيعة الجسدية لكل الذين لم يؤمنوا به قد تحررت وأحيت من جديد من خلال هذا الحدث وهذا السر.
في المستقبل، لن يبقى الوعي البشري كما هو عليه اليوم، لأن هذا الوعي سيصبح عاملاً فاعلاً ومحركاً أساسياً لتطوّر الإنسانية جمعاء في الوعي والمعرفة، كما ان هذه المعرفة الواعية هي التي ستطوّر البشرية جمعاء نحو مملكة الروح، هذا التطوّر التصاعدي هو من الأهداف التي تسعى إليها علوم الانتروبوصوفيا الروحية، التي ستعطي في النهاية مفهوماً جديداً عن المسيح الكوني إذا فهمت بالشكل الصحيح.
إن علوم الانتروبوصوفيا، سوف تكشف لإنسان اليوم، أنه وقبل حدوث “سر الجلجثة” كان بإستطاعة البشرية جمعاء الاتصال “بإله- الشمس” (المسيح) فقط من خلال القوى الروحية الفائقة الطبيعة، التي كان يمتلكها الإنسان آنذاك بالفطرة. أما الآن، وبحسب تلك العلوم، فإن البشرية باتت قادرة على بلوغه ومعرفته بطريقة واعية، من خلال قوة المعرفة المكتسبة هنا على الارض في عالمنا المادي الصرف. إن الإنسان سيدرك مرة أخرى بطريقة واعية وواضحة معنى عبارة “ملكوت السماوات قد نزل إلى الارض” ولن يعود يتحدث عن هذا الملكوت بعبارات غامضة وصوفية، اذ انه سيصبح قادرا أن يشعر بطريقة واعية ودائمة، حقيقة ماذا اختبر الرسل في داخلهم في الزمن الذي حل فيه “سر العنصرة”، أي عندما نزل “المسيح” بنفسه إلى الارض.
هذا يعني، أنه بواسطة العلوم الروحية، علينا أن نتعلم من جديد على فهم تلك الحقيقة الروحية الكامنة في كل ما تحمله الطبيعة المادية من اسرار. بعبارة أوضح علينا ان نفهم، الحقيقة الروحية وراء الحجارة، النباتات، الحيوانات والبشر، ووراء الغيوم والنجوم والشمس. فعندما نصبح قادرين على “رؤية واعية” لحقيقة، ان كل ما هو مادي هو تجسد لروح الله الكلي، فإننا بهذه الرؤية وبهذا المنطق الروحي، نفتح نفوسنا لسماع صوت المسيح الذي سيحدثنا إذا كنا على استعداد للإستماع إليه.
إن القوة التي تضمن الخلود للبشر قد تجلت في قلوبنا مع كلمات المسيح: “انا معكم دائما حتى انقضاء الدهر” والتي يجب أن تؤخذ بجديتها وبمفهومها الحقيقي والروحي العميق. حتى ولو أن أعداداً قليلة من البشر حتى الآن قد اعترفوا بهذا للعلن، فإن سر العنصرة، ستترسخ أكثر وأكثر في العديد من البشر في وقتنا الحاضر وفي المستقبل، لأن من أتى كانت البشرية بأمس الحاجة اليه، من أجل فدائها وخلاصها. إنه الروح الشافي المحيي الذي سيخاطب تلك القدرات الإدراكية الجديدة في الانسان، أنه الروح القدوس التي بواسطته ستلتئم نفوس البشر السقيمة، إنه الروح الذي بعثه المسيح. بعدها سيأتي ما تحتاج إليه البشرية جمعاء أي “العنصرة الكونية…“.
***
رودولف شتاينر لإنسان عصر الذرّة: وعي المادة والفكر، الموجة – الحركة.. ضرورة لنكران الذات
– “نكران الذات” لتحييد البشرية عن حافة الدمار وحرب الجميع ضدّ الجميع
رودولف شتاينر لإنسان عصر الذرّة: وعي المادة والفكر، الموجة – الحركة.. ضرورة لنكران الذات
 Agoraleaks Agoraleaks
Agoraleaks Agoraleaks