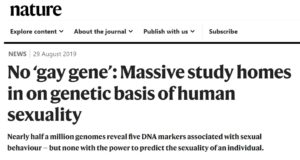«من يتخلى عن حريته خوفاً على أمنه، لا يستحق حريّة ولا يستحق أمناً»- بنجامن فرانكلن (1)
من البديهي أن يترافق تطور الإنسان عبر العصور مع تطور مفاهيم اجتماعية عدة، أهمّها الحرية بكل أجزائها ومعانيها.
فمبدأ نشوء المجتمعات خضع للبحث لدى الكثير من العلماء. الفارابي مثلاً شدد على أنّ الإنسان بفطرته لديه حاجات ماديّة ومعنوية، لذلك يتعاون مع أبناء قومه لتحقيق هذه الاحتياجات (2). ومن هنا نفهم أنّ قيام المجتمعات مرتبط بفطرة الإنسان الثابتة مع الزمن، وقوامها المادّة والاستقرار.
فمن جهة، يسعى الإنسان لتحقيق الاستقرار والديمومة عبر المادّة (أي المال). من جهة أخرى يحتاج إلى الاستقرار المعنوي الذي يؤدي إلى عمل الإنسان وتطوره على الأصعدة كافّة ضمن الجماعة.
إنما يبقى العنصر الأهم في كلّ هذه التركيبة الاجتماعية، هو الأمن.
فمن دون هذا العنصر، لا يمكن للكائن البشري أن يحقق المفاهيم التي تحدثنا عنها من تجارة وربح وعلم وتطور…
التاريخ نفسه شاهد على أن نشوء الأمم وازدهارها كان ولا يزال مرتبطاً بالأمن والاستقرار، وهما يدخلان في مفهومين محددين:
الأوّل: الأمن الداخلي أي ضمن الحدود المعترف بها. حدود المجموعة أو المدينة أو البلد أو الإمبراطورية.
الثاني: الأمن الخارجي: خارج هذه الحدود، وهو مرتبط مباشرة بالأمن الداخلي. من هنا نستطيع أن نفهم طبيعة الحضارات والأمم التي كانت ولا تزال تشنّ حروباً خارجية، ليس فقط لفرض هيبتها وثقافتها وتقاسم مغانم حروبها، إنما أيضاً لتوسيع حدود أمنها الداخلي، فتعمد بعد فرض سيطرتها الخارجية، إلى نشر تعاليمها على مواطنيها الجدد لحثّهم على الاندماج ضمن حدودها، وبذلك يكون المحتل الجديد قد غيّر مجتمعاً مغايراً له، فيذوب الكلّ في مفهوم اجتماعيّ واحد.
اما فكرة الحريّة فكانت ولا تزال ناقصة في كثير من العصور، لأنها مرتبطة بالفكر، فنجدها مجتزأة وذلك لعوامل عدّة أهمها: قيام امبراطوريات، حروب، أديان…
هذه العوامل تعمل بعكس الفكر، لكنها وجدت وتطورت منذ الإنسان الأول، لكنها بقيت أسيرة مجموعة متمايزة معهم وضد غيره.
فمثلا الحرية كانت موجودة فقط للروماني الحرّ دون سواه أو للمسلم في ممارسة شعائره علناً دون سواه أو لجنود الإمبراطور الفارسي أو الإسباني دون سواهم..
فهذه التجزئة في ممارسة الحريّة أدّت إلى قيام ثورات، بينها الثورة الفرنسية، التي أرست مبدأ الحرية والمساواة للجميع، أفكاراً ومفاهيم غيرت العالم الحرّ (3).
تبعتها طبعاً ثورات مماثلة في عصرنا الحالي، كثورتي السود في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.
إذاً، المجتمعات تغيرت مع الحرية وأضحت تلك الكلمة ملاصقة لأي عمل ثقافي أو اجتماعي. كلّ هذا التحول حصل منذ أربعمئة سنة.
أمّا اليوم، فالخوف من العودة إلى الوراء، إلى ما قبل عصر التنوير، أصبح حقيقة، بطله الأمن والاستقرار.
فمع تطور نظرية صراع الحضارات لهنتنغتون (4)، تأسست معها تيارات تؤمن بهذا الخلاف العميق الذي سيؤدي حتماً إلى قيام حروب جديدة. فالنماذج التاريخية لهذا الصراع كثيرة وهي تستهدف بشكل أساسي مفهوم الحرية.
نذكر ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حملته الانتخابية حين اتهم مباشرة إدارة الرئيس أوباما ومنافسته هيلاري كلينتون بأنها أوجدت داعش (5). هذا التنظيم، في نظرية تصارع الحضارات، يمثل الظلمة والتخلف ويعمل على زعزعة الأمن في كل الدول المتقدمة، ويتقصد مصارعة كل ما لا يتفق معه من حضارات وأديان.
ولأن هذا التنظيم يتواجه مع أطراف متعددة، فإن التغييرات الاجتماعية التي يحدقها لا تقتصر على بيئته إنما على مختلف المجتمعات التي يتواجه معها، خصوصاً في البلدان التي اختارت الحرية قاعدة أساسية لتطورها.
فصحيح أن الحضارة أو الحركة الاجتماعية الأولي التي أشرنا إليها ستخسر مكانتها الدينية وكل ميزاتها، وسيتشوه الإسلام والمنطقة كلها بفعل ظلم أفعالها، أي داعش وكل من يتعاطف معها، وإنما الحضارة الثابتة والتي تقاتل الأولى، هي أيضاً ستخسر أهم ما عندها أهم ما قاتل الكثيرون في سبيلها وسبيل تقدمها ألا وهي الحرية مقابل الأمن.
القلق الحقيقي الآن يكمن في أن ينتج هذا الصراع تفضيلاً أوروبياً وأميركياً للحرية مقابل الأمن. هذا الواقع سيعيدهم إلى زمن الفارابي حيث سينكبّون على همين: المعونة والمعنويات من خلال تثبيت امنهم والتخلي عن حريتهم. وإذا ما حصل هذا كله يكون انتهى عصر العولمة والتنوير ليعودوا بنا إلى عصر العصبيات والحدود المغلقة. خسارة جديدة للحرية التي من أجلها ضحى كثيرون وماتوا.
 Agoraleaks Agoraleaks
Agoraleaks Agoraleaks